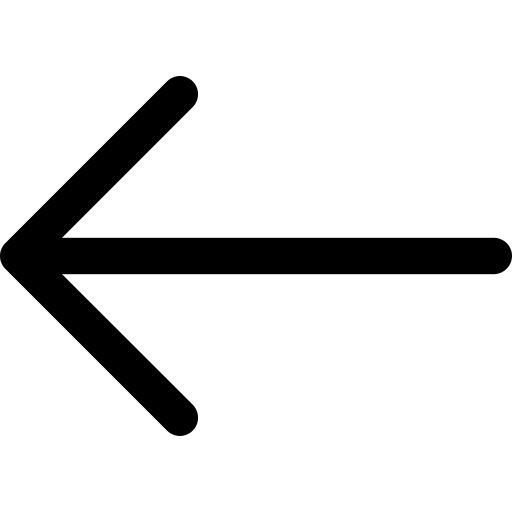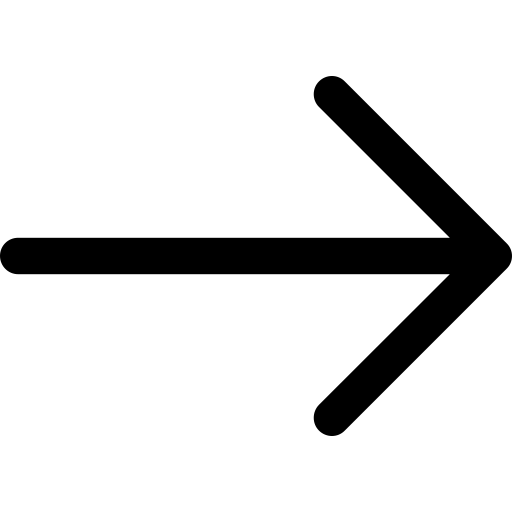يُفترض أن التضخم تحت السيطرة عند حوالي 2.7%. ويؤكد المحللون أننا نعود إلى وضع اقتصادي آمن. ولكن إذا كنتَ تنظر إلى فاتورة بقالة بقيمة 150 دولارًا، أو تتساءل عن سبب زيادة سعر غطاء هاتفك بنسبة 25%، فأنتَ تعلم أن هناك خطبًا ما. مؤشرات التضخم مضللة، وخطيرة.

لم تُصدّق دوروثي غيل الثالثة القصص قط. ليس تمامًا. ليس كما روتها جدتها. لكنها كانت تُحبّ الاستماع. في صغرها، كانت تجلس بجانب العجوز على شرفة أمامية واسعة في كانساس، حيث الهواء مُثقل بحشرات السيكادا ورائحة حقول الذرة. وكانت القصص تتدفق كالسحر.

زعزع روبرت كينيدي الابن ريادة الولايات المتحدة في مجال اللقاحات، مما أثار قلقًا عالميًا بسحب تمويل تحالف غافي، وأعاد إحياء مزاعم مُدحضة. إليكم ما يعنيه هذا لكم.

تخيّل أنك تعيش في مدينة يمكنك فيها رؤية الشقق الفاخرة من نافذتك، لكنك لا تستطيع شراء خس على بُعد خطوات. هذه ليست مزحة بائسة، بل هي واقع الحياة اليومية في أجزاء من نيويورك. وبينما يتجادل السياسيون حول الشعارات، تعمل المجتمعات بهدوء على بناء حلّ أفضل: الملكية، والتعاون، والرأسمالية التي تُغذّي الناس بالفعل.

أطلق دونالد ترامب عليه اسم "مشروع القانون الكبير الجميل". لكن بالنسبة لستة عشر مليون أمريكي على وشك فقدان رعايتهم الصحية، فهو أشبه بخيانة "الجميل الكبير". هذه ليست سياسة، بل نشل سياسي مُقنّع بعلم الولايات المتحدة. ومثل خدعة سحرية رخيصة، لا يبدأ الألم الحقيقي إلا بعد الانتخابات. من المضحك كيف تسير الأمور، أليس كذلك؟

تحولت محاولة إدارة ترامب لجعل الحكومة الفيدرالية أكثر مرونة إلى درسٍ مُكلفٍ حول ما يحدث عندما تتغلب الأيديولوجية على الكفاءة. في حين أمضى السياسيون عقودًا في التذمر من عدم كفاءة الحكومة الأمريكية المزعومة، إلا أن الحقائق تُخبرنا بقصةٍ مختلفة. والآن، مع إهدار الملايين على تسريح الموظفين الفيدراليين الأساسيين ثم إعادة توظيفهم، بات واضحًا من هم مروّجو عدم الكفاءة الحقيقيون - وهم ليسوا موظفي الخدمة المدنية المحترفين.

نحن نتجه نحو كارثة اقتصادية، وقد ضغط قائد القطار للتو على دواسة الوقود. تواجه كندا والولايات المتحدة نقصًا حادًا في المهارات وأزمة في القوى العاملة، ولكن بدلًا من الضغط على المكابح، يُعيق قادة مثل دونالد ترامب سير الأمور. دعك من النقاشات الأيديولوجية للحظة - إذا لم نُصلح التفاوت المتزايد بين التعليم والمهارات والطلب على الوظائف، فلن يُنقذنا أي قدر من التباهي من انهيار الإنتاجية الذي يجعل الركود الكبير يبدو مجرد عثرة.

خلال الحرب العالمية الأولى، شيّدت الحكومة الأمريكية 80 مجمعًا سكنيًا عامًا في غضون عامين فقط، تضم منازل مزودة بحدائق ومدارس وشبكات صرف صحي. وقد وفّر هذا المشروع الطموح، بقيادة مؤسسة الإسكان الأمريكية، مساكن لما يقرب من 100,000 ألف شخص، ووضع معايير تخطيطية لا نزال نستخدمها حتى اليوم. إنه إرثٌ منسيّ يُثبت أن العمل الحكومي الجريء قادر على حل أزمة الإسكان، حتى في زمن الحرب.

عاد دونالد ترامب إلى مسار الحرب التجارية، وهذه المرة، لم يكتفِ بتغريد التهديدات، بل وعد بإرسال رسائل فعلية إلى شركاء أمريكا التجاريين، موضحًا فيها معدلات الرسوم الجمركية كما لو كانت فواتير متأخرة. وكما هو الحال في كل جولة من هذه الأزمة الاقتصادية، فإن المستهلكين الأمريكيين ليسوا مجرد مشاركين في هذه الرحلة، بل هم من يدفعون الفاتورة. فما الذي يدور حقًا وراء هذا المزيج الغريب من التهويل والأوراق الرسمية وارتفاع الأسعار؟ دعونا نحلل الأمر.

في عالمٍ يتصرف فيه المليارديرات كآلهة، ويحكم فيه الرؤساء التنفيذيون بسلطةٍ تفوق ما حلم به الملوك، من السهل أن ننسى أن هذا لم يكن الحال دائمًا. في الواقع، في قديم الزمان، حتى الفلاحون كان لهم سيدٌ مدينٌ لهم بشيءٍ في المقابل. هذه قصة كيف انتقلنا من الالتزام المتبادل إلى قابلية الاستغناء الاقتصادي - وكيف يُفكك الخوف، مدفوعًا بالربح، الديمقراطية خيطًا تلو الآخر.

ماذا لو لم تكن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) موجودة؟ إنها ليست مجرد تجربة فكرية سياسية، بل سؤالٌ يُلامس جوهر تعريفنا للمسؤولية والتنسيق والمرونة في زمن الكوارث المتفاقمة. مع اشتداد الأعاصير، وانتشار حرائق الغابات، وتصدع البنية التحتية تحت وطأة الضغوط، غالبًا ما تكون شبكة الأمان الفيدرالية التي توفرها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) آخر ما يفصل بين الفوضى والتعافي. ولكن ماذا لو اختفت تلك الشبكة بين عشية وضحاها؟

هل شعرتَ يومًا أن الاقتصاد ينهار من حولك، بينما تُصرّ العناوين الرئيسية على أنه لم يكن يومًا أفضل؟ لستَ مجنونًا. هذا الشعور المقلق - ذلك الانفصال بين واقعك المعاش والأرقام الرسمية - له اسم: التلاعب الاقتصادي. وهو ليس مجرد أثر جانبي للعجز، بل هو استراتيجية.

يُهدد دونالد ترامب مجددًا بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. هذه المرة، ليس الأمر مجرد تهديدات انتخابية، بل إنه يستهدف جيروم باول كما يستهدف الرئيس التنفيذي متدربًا عاصيًا. لكن المشكلة تكمن في أن الاحتياطي الفيدرالي ليس كازينو ترامب أو منتجع غولف عائليًا. إنه آخر مؤسسة شبه مستقلة تُمسك بزمام الأمور الاقتصادية. إذا فاز ترامب واستولى على السلطة، فلن نواجه التضخم فحسب، بل سنواجه طغيانًا اقتصاديًا مُتخفيًا تحت شعار "أمريكا أولًا".

يُقال إن سوق السندات يُدير العالم. يرتعد الرؤساء لمجرد التفكير في إغضابها. ويعاملها الخبراء كوحش غامض يجب إرضاؤه باستمرار. هل يُقترح توفير الرعاية الصحية للجميع؟ قد يُصاب سوق السندات بالذعر. هل نتحدث عن تخفيف ديون الطلاب؟ قد يُرد سوق السندات انتقامًا. هل نتحدث عن البنية التحتية الخضراء؟ من الأفضل مراجعة وول ستريت أولًا. لكن لنكن واضحين: هذا الخوف مُصطنع. ليس اقتصاديًا، بل تمثيلية. "خوف سوق السندات" و"خرافة الدين الفيدرالي" هما أقدم الحيل في عالم التلاعب السياسي.

بيتر نافارو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد. دع هذا يستوعبك. الرجل نفسه الذي ساهم في إشعال حرب تجارية مع الصين بتطبيق أفكار القرن التاسع عشر على اقتصاد القرن الحادي والعشرين، تلقى تدريبه في إحدى أعرق المؤسسات التعليمية في العالم. إذا لم يُزعزع هذا ثقتك بمؤهلات جامعات آيفي ليج، فينبغي أن يُزعزعها. لأن هوس نافارو بالرسوم الجمركية لا يُفشله فحسب، بل يكشف أيضًا عن مدى خطورة ابتعاد النظريات الاقتصادية النخبوية عن الواقع عندما تُحرف وتُصبح أيديولوجية.

عندما يبدأ الناس بالتصويت بأموالهم، يلاحظ السياسيون ذلك في النهاية. ولكن ماذا يحدث عندما لا تُغلق المحفظة فحسب، بل تُوجّه في اتجاه آخر؟ مع تزايد الإحباط العالمي من سياسات الولايات المتحدة، يُدير المزيد من المواطنين حول العالم ظهورهم للسلع الأمريكية الصنع، ويتجاهلون كتيبات العطلات البراقة. والنتيجة؟ أكثر خطورة بكثير مما تُظهره وسائل الإعلام.

هل يمكن لرمزك البريدي أن يتنبأ بمتوسط عمرك المتوقع؟ قد لا يكون الأمر بهذه البساطة، لكن دراسة رائدة تُشير إلى أن رصيدك البنكي قد يفعل ذلك. بمقارنة كبار السن في الولايات المتحدة وأوروبا، وجد الباحثون أن الثروة ليست مجرد امتياز، بل هي مسألة حياة أو موت. وإذا كنت تعيش في أمريكا، فقد لا يكفيك الثراء لإنقاذ حياتك.

هل تذكرون سبعينيات القرن الماضي؟ ركود تضخمي، وطوابير وقود، وبدلات رياضية من البوليستر، ورائحة الخلل الاقتصادي الواضحة؟ آنذاك، كان أباطرة النفط الأجانب هم من يتحكمون بالأمور. أما هذه المرة، فلم يحالفنا الحظ. فالفوضى لا تأتي من وراء المحيط، بل تُدبّرها الإدارة في المكتب البيضاوي، ظنًا منها أن أفضل طريقة لإنعاش الاقتصاد هي جرّه إلى الوراء عبر غابة من الرسوم الجمركية والحروب التجارية وسلاسل التوريد المعطلة. أهلاً بكم في عام ٢٠٢٥، حيث يرتفع التضخم، وينكمش النمو، ونعم، نحن من نتسبب في ذلك بأنفسنا.

يُعدّ المحاربون القدامى من بين أكثر المرضى مرضًا في أمريكا، ومع ذلك تُقدّم لهم إدارة شؤون المحاربين القدامى علاجًا أكثر فعالية من حيث التكلفة من الرعاية الصحية الخاصة. والآن، تُهدّد التخفيضات الشاملة لميزانية إدارة شؤون المحاربين القدامى التي أقرّها ترامب وماسك بقلب هذا النظام رأسًا على عقب، مما يُخلّف 900,000 ألف طلب إعانة إعاقة مُتراكمة، و40,000 ألف محارب قديم بلا مأوى، وحالات انتحار في ازدياد.

مع تراجع الحكومة الفيدرالية عن تمويل الإغاثة من الكوارث، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، وإنفاذ القانون، ستسعى الولايات جاهدةً لسد الفجوة. ولكن هل يمكنها تحقيق ذلك دون رفع الضرائب بشكل كبير؟ وإذا رفعت الضرائب، ألن يرحل الأثرياء ببساطة وينتقلوا إلى ولايات منخفضة الضرائب، مما يخلق منافسة شرسة على أقل المعدلات الضريبية الممكنة؟

سياسات ترامب الاقتصادية مبنية على الوهم، وسيدفع العمال الأمريكيون ثمن هذه الأوهام. بينما يُلهي ترامب مؤيديه بالحديث عن التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب و"إعادة" التصنيع، تلوح الأزمة الاقتصادية الحقيقية في الأفق: انهيار ناجم عن تغير المناخ. فبدلاً من الاستعداد لتحديات القرن الحادي والعشرين، يُضاعف ترامب جهوده في نموذج اقتصادي فاشل يعود إلى خمسينيات القرن الماضي. ولكن هناك طريقة أخرى - استراتيجية ناجحة بالفعل. لو كنتُ ملكًا، لأطلقنا حملة تعبئة اقتصادية على غرار الحرب العالمية الثانية، حملة تُقوي أمريكا بدلًا من أن تُضعفها.

مع تزايد المخاوف بشأن النفوذ السياسي الأمريكي واحتكارات الشركات، يفكر الكنديون في شكل غير مألوف ولكنه قوي من الاحتجاج: مقاطعة المنتجات الأمريكية. فهل تكون خيارات المستهلكين مفتاحًا للتصدي للهيمنة الاقتصادية الجامحة؟

في كل ربيع وخريف، نمر بنفس الطقوس - تقديم أو تأخير ساعاتنا بمقدار ساعة. ولكن بعيدًا عن الإزعاج البسيط المتمثل في قلة النوم أو اضطراب الروتين، ما هي التكلفة الحقيقية للتوقيت الصيفي (DST)؟ من التأثيرات الاقتصادية إلى العواقب الصحية، فإن تغيير الساعات مرتين في السنة يحمل تكاليف كبيرة غالبًا ما يتم تجاهلها. هل حان الوقت لوقف هذه الممارسة العتيقة؟